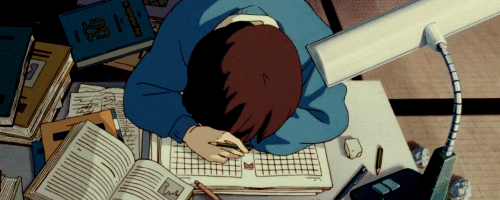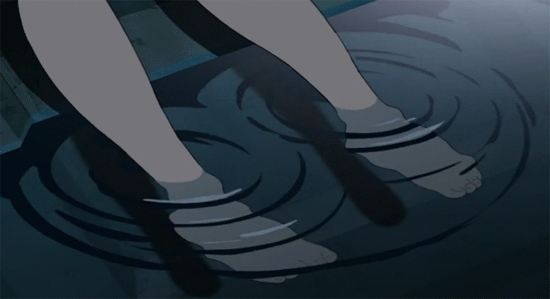الأربعاء الماضي كان يومًا استثنائيًا في مسيرتي الطويلة في مجال الترفيه عن الذات، فبعد امتحانين شبه سيئين و مع كل اليأس الذي تحمله علامة غير جيدة قررت أن لا أعود للقرية هذا اليوم و أتوجه مباشرة لدبي، كنت على علم مسبق بعرض فلم الجوكر لأول مرة هذا اليوم بعد انتظار دام أمدًا طويلًا، راسلت أخي الأكبر بعد خروجي من الامتحان الأخير صباحًا أخبره بالخطة لهذا اليوم ” أنا قادمة احجز التذاكر قبل النفاد و بوب كورن بالكارميل الحجم العائلي” أبدى اعتراضه لمشاهدة الجوكر لأنه سبق و هيّأ نفسه لمشاهدة فلم “وُلد مَلِكًا” لكن الفوز بيومه كان من نصيبي، يدًا بيد كنّا أمام قاعة العرض ننتظر بدء الجوكر.

المشهد الوحيد الذي كنت أنتظر رؤيته في الحقيقة كان مشهد الحافلة الذي عُرض في إعلان الفلم، و قد أتى الإعلان موضِّحًا أن هذا الفلم لن يكون كباقي سلسلة فارس الظلام (و هي بالمناسبة سلسلة أفلام الأبطال الخارقين الوحيدة التي أحبها) حيث يلعب الجوكر فيها شخصية الشرير المجنون الذي لا يتوانى عن قتل الضعفاء و تفجير المستشفيات و نشر الإرهاب في غوثام المدينة المغمورة في الخطيئة والفساد و التي يتسابق على عمادتها علّية القوم و بالخصوص من يجهل منهم تمامًا ما يحدث في الشوارع و خارج أسوار منازلهم الفسيحة، هذا الفلم يحكي بوضوح ماضي المهرج المختل المدعو بالجوكر و الأسباب التي قد تدفع بشخص لطيف بارّ بوالدته و أصحابه كآرثر فيليك ليصبح قاتلًا عديم الإحساس و الشفقة.

قبل البدء بسرد كل ما يجب سرده عن هذا الفلم يجدر بي التنويه لمحاسن الصدف التي جعلتني أقرأ رواية “أنشودة المقهى الحزين” في يوم مشاهدة الفلم نفسه، استيقظت في منتصف الليل قرأت الرواية درست ثم أتممت محاضراتي و توجهت لدبي، بالإضافة لرغبتي الشديدة في شكر عقلي على احتمال أيام طويلة كهذه أودّ أيضًا شكره على الربط الرائع للرواية و الفلم و التحليل لشخصيتين أساسيتين في العملين، إيميليا صاحبة المقهى و آرثر فيليك الجوكر.


تحكي الرواية قصة مقهى بسيط كان يومًا ما المكان الوحيد للترفيه في بلدة أمريكية صغيرة بالقرب من شلالات فوركس، إيميليا المرأة القوية بالمعنى الحقيقي لكلمة قوية فهي تملك يدًا تكسر كل ما يمكن كسره حتى عظام الآخرين، كما أن الجميع يهابها و يخشى أن ينبس ببنت شفة عنها في حضورها، و لها مقهى تبيع فيه خمر مقطرتها الخاصة وتمنع أيًا كان أن يجلس للشرب لديها فمن يريد خمرها يبتاع زجاجته و يخرج في أي “داهية” ليشرب، و لا أحد يتجرأ على كسر هذه القاعدة، حتى يظهر في الأفق ذات يوم أحدب صغير يتوجه مباشرة للمقهى و يخبر إيميليا بحضور بعض سكّان البلدة أنه ابن خالتها بالرضاعة ما جعل الجميع يطرقون داعين له بالرحمة لعلمهم يقينًا بأن إيميليا سترديه قتيلًا هاهنا، الشخصية الصلبة المجرمة لإيميليا كانت تحتّم على الجميع صنع خيالات كهذه لكن ماذا سيحدث لو قررت هذه الشخصية أخيرًا أن تفتح قلبها للشخص الخاطئ؟
في وصف مثير للشفقة تتحدث فيه كاتبة الرواية عن إحدى الشخصيات التي واجهت ماضٍ مؤلم حوّلها في النهاية لشخصية اجرامية مريعة ” إن قلوب الأطفال الصغار أعضاء مرهقة، إن بدايةً وحشيةً في هذا العالم بوسعها أن تشوّهها إلى أشكال غريبة. يمكن أن ينكمش قلب طفل مجروح بحيث يغدو بعد ذلك صلبًا و منقَّرًا إلى الأبد مثل بذرة دراق، أو مرة أخرى قد يتقيح قلب طفل كهذا و ينتفخ حتى يكون معاناةً تُحمل في الجسد سرعان ما تغيظها أكثر الأشياء عاديةً أو تؤذيها” و هذا بالضبط ما حدث لآرثر أيضًا في فلم الجوكر، آرثر هو مهرج بسيط يسعى لأن يصبح ممثلًا كوميديًا لكن معاناته الخاصة كانت تطغى على كل محاولاته الفكاهية و بالتالي تصبح مثيرة للضحك عليه لا على نكته، هذا ما حاول آرثر أن يتغلب عليه بأن ينطوي على نفسه و يقضي وقته بعد خروجه من المصحّ النفسي في الاهتمام بوالدته المريضة و مراجعة الطبيبة النفسية التي كان يشعر بأهميتها من ناحية كتابة وصفات الأودية لا أكثر، فقد شعر فيليك أن أحدًا لا يهتم و لا يفهم رغبته الحارقة بإضحاكهم، في الرواية السابقة و في وصف للرجل ذاته الذي كان بطريقةٍ ما يشابه هذا المهرج الغريب ” إنه رجل حَيِيٌّ و عليه أمارات الرجل الذي يحمل في جوفه قلبًا متورمًا و يعاني“.
نتيجة للماضِ الصعب و الحياة المريعة التي عاشها آرثر فقد أصيب بمرض يدعى التقلقل العاطفي و من لفظه يمكن لأيٍّ كان أن يكتشف أعراضه، نوبات الضحك أو البكاء الفجائية كانت واحدة من أهم هذه الأعراض وهو الأمر الذي يميز الجوكر حتى لمن لم يتابع أيًا من الأعمال التي ظهرت فيها هذه الشخصية، يأتي أخيرًا في هذا الفلم الكشف عن سبب هذه الضحكة الرنانة المريبة، الجدير بالذكر أن خواكين فينيكس (وهو الممثل الذي لعب دور الجوكر في هذا الفلم) قد خسر من وزنه ما يقارب الخمسة و عشرون كيلوجرامًا ليتمكن من الوصول للحالة الجسدية التي كان فيها آرثر فيليك نتيجة مرضه وفقره، وهو أول تعليق صدر من أخي بداية الفلم “هذا كيف وصل لهالجسم!” بينما وجدته أمرًا عاديًا فعله قبله العديد من الممثلين بغية الوصول للتجسيد المثالي لشكل الشخصية الخارجي أما على الصعيد الداخلي فقد أمضى خواكين وقتًا ليس بالهيّن في الاستماع لضحكات مرضى التقلقل العصبي والتدرّب على مثلها، في كل المقاطع التي ظهرت فيها ضحكته كنت أودّ لو أضع يدي في أذني بينما كان الجميع يضحك بصوت عالٍ إلّاي و زوجة أخي التي أخبرتني بصوت مرتجف أثناء إحدى المشاهد الدموية التي ضحك فيها آرثر و جميع من في القاعة ” قلبي يعورني، هذيل كيف لهم خاطر يضحكون؟” و كنت أتعجب فعلًا من طريقة تفاعل الجمهور مع الفلم في كثير من المقاطع و أعزو معظمها لاعتيادهم على ضحكته لا أكثر.

إيميليا تتعرض لخيانة تغيّر مجرى حياتها و تفتت هذه الصلابة المخيفة بينما يحدث العكس تمامًا مع آرثر حيث جرح خيانة صديقه له كان سكينًا كشفت القشرة التي تغلّف قلبًا صلدًا يفتك بكل ما يعترض طريقه، و حدث أن كنت أقرأ سابقًا في أحد المواضيع العلمية التي تطرح كل التأثيرات الممكنة التي قد يُحدثها ماضٍ قاسٍ على الضحية و التي انقسمت بشكل رئيسي لثلاثة ردود فعل إمّا التدمير الكامل للضحية أو ردة الفعل العكسية التي تؤدي لتكوين شخصية قاسية على الجميع بدءًا بنفسها و الثالث كان الطريق الذي حالف الحظ القليلون فقط ليعبروه وهو طريق العودة للذات بهدوء و التصالح مع ما حدث، في جميع الحالات كان حدثًا كهذا مفصليًا في حيواتهم.
حين أوصلني أخي لمحطة الباص بالأمس و ناولني حقيبتي التي جهّزتها للسكن الجامعي لوّحت بيدي و أخبرته صارخةً في وجه ريح الشتاء القادمة بقوة “يوم الأربعاء برجع دبي إن شاء الله لا تشوف فلم الملك فيصل بدوني” وهكذا رتّبت ترفيهًا لأسبوع شاقّ محتمل.